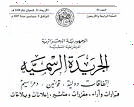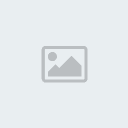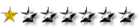مع أن جميع اليهود والنصارى كانوا يعرفون أنه رسول الله إلا أن حقدهم وحسدهم كان
ولا يصرح الله تعالى في هذه الآية باسم نبيه، بل يذكره بضمير الغائب (ـه)، وهذا يشير إلى أن جميع أهل الكتاب كانوا يعرفون خاتم الأنبياء؛ لذا، فعندما ذكره بالضمير، كانوا يعرفون أنه يعني النبي المذكور اسمه في التوراة والإنجيل، وهو سيدنا أحمد أو محمد عليه الصلاة والسلام، إذ كانوا يعرفونه أكثر مما يعرفون أبناءهم.
ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لعبد الله بن سلام: “أتعرف محمداً كما تعرف ولدك؟” قال: “نعم وأكثر، نزل الأمين من السماء على الأمين في الأرض بنعته فعرفتُه، وابني لا أدري ما كان من أمه.”([1])
الغيرة والحسد
أجل، لقد كانوا يعرفون رسول الله صلى الله عليه و سلم معرفة جيدة، ولكن الإيمان شيء، والمعرفة شيء آخر.. كانوا يعرفونه ولكن لا يملكون الإيمان به؛ فغيرتهم وحسدهم وقفا حائلاً أمام إيمانهم، ومانعاً له.
{ولـمّا جاءهم كتاب من عند الله مصدِّق لِما معهم وكانوا من قبل يَستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين} (البقرة: 89). يشرح الله تعالى في هذه الآية السبب الحقيقي لعدم إيمانهم برسول الله صلى الله عليه و سلم؛ فالقضية كلها تنحصر في عدم كون خاتم الأنبياء يهودياًّ. فلو ظهر رسول الله صلى الله عليه و سلم من بين اليهود، لكان تصرفهم مختلفاً دون شك.
والدليل على هذا أن عبد الله بن سلام بعد أن أسلم قال لرسول الله صلى الله عليه و سلم: “يا رسول الله! إن اليهود قوم بُهْتٌ، إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بَهَتُوني عندك.” فجاءت اليهود ودخل عبد الله البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «أيّ رجل فيكم عبد الله بن سلام؟» قالوا: أعلمُنا وابن أعلمنا، وأَخْيَرُنا وابنُ أَخْيَرِنا. فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «أفرأيتم إن أسلم عبد الله؟» قالوا: أعاذه الله من ذلك..فخرج عبد الله إليهم فقال: “أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله.” فقالوا: شرّنا وابن شرّنا. ووقعوا به.([2])
وهذه الحادثة تبين بجلاء أن اليهود كانوا يعرفون رسول الله ولا يجهلونه، غير أن عنادهم منعهم من الإيمان به.
ويُعدّ سلمان الفارسي رضي الله عنه دليلاً قائماً وحده في هذا الموضوع.. فقد كان مجوسياًّ أول الأمر، ولكنه كان يتحرّق شوقاً للعثور على الدين الحق، فدخل إلى المسيحية وتَنصّر واعتكف في الكنيسة، وعندما حضرت الراهبَ المنتسب إليه الوفاةُ سأله أن يوصيه راهباً آخر، فوصفه له، وهكذا انتقل من راهب إلى راهب، وصحب كثيراً منهم، وأخيراً سأل السؤال نفسه من راهب شيخ يعيش الدقائق الأخيرة من حياته، فقال له ذلك العالم النصراني:
أيْ بنيّ، واللهِ ما أعلمه أصبح اليوم أحد على مثل ما كنا عليه من الناس آمرك به أن تأتيه، ولكنه قد أظل زمان نبي، وهو مبعوث بدين إبراهيم عليه السلام، يخرج بأرض العرب، مُهاجَره إلى أرض بين حَرّتين،([3]) بينهما نخل به علامات لا تخفى، يأكل الهدية، ولا يأكل الصدقة، وبين كتفيه خاتم النبوة، فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل.
قال ثم مات، وغُيِّب، ومكثت بعَمُّورية ما شاء الله أن أمكث، ثم مر بي نفر من كَلْب([4]) تجّار، فقلت لهم: اِحْمِلوني إلى أرض العرب، وأعطيكم بقراتي هذه، وغُنيمتي هذه. قالوا: نعم، فأعطيتهموها، وحملوني معهم، حتى إذا بلغوا وادي القُرى ظلموني، فباعوني من رجل يهودي عبداً، فكنت عنده، ورأيت النخل، فرجوت أن يكون البلد الذي وصف لي صاحبي، ولم يَحِقَّ في نفسي. فبينا أنا عنده إذ قدم عليه ابن عم له من بني قريظة من المدينة، فابتاعني منه، فاحتملني إلى المدينة، فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفتها بصفة صاحبي، فأقمت بها. وبُعث رسول الله صلى الله عليه و سلم، فأقام بمكة ما أقام لا أسمع له بذكر مع ما أنا فيه من شغل الرق. ثم هاجر إلى المدينة، فواللهِ إني لفي رأس عَذْق([5]) لسيدي أعمل له فيه بعض العمل وسيدي جالس تحتي، إذ أقبل ابن عم له حتى وقف عليه، فقال: يا فلان، قاتل الله بني قَيْلَة، واللهِ إنهم الآن لمجتمعون بقُباء([6]) على رجل قدم عليهم من مكة اليوم، يزعمون أنه نبي.
قال سلمان: فلما سمعتها، أخذتني العُرَواء([7]) حتى ظننت أني سأسقط على سيدي، فنزلت عن النخلة، فجعلت أقول لابن عمه ذلك: ماذا تقول؟ فغضب سيدي، فلكمني لكمة شديدة. ثم قال: ما لك ولهذا! أَقْبِلْ على عملك. قلت: لا شيء، إنما أردت أن أستثبته عما قال.
وكان عندي شيء قد جمعته، فلما أمسيت أخذته ثم ذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو بقُباء. فدخلت عليه، فقلت له: إنه قد بلغني أنك رجل صالح، ومعك أصحاب لك غرباء ذوو حاجة، وهذا شيء قد كان عندي للصدقة، فرأيتكم أحقَّ به من غيركم. قال: فقربته إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لأصحابه: «كلوا!»، وأمسك يده فلم يأكل. فقلت في نفسي: هذه واحدة. قال: ثم انصرفت عنه، فجمعت شيئاً، وتحول رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى المدينة، ثم جئته به، فقلت: إني قد رأيتك لا تأكل الصدقة، وهذه هدية أكرمتك بها. قال: فأكل رسول الله صلى الله عليه و سلم منها، وأمر أصحابه فأكلوا معه. قال: فقلت في نفسي: هاتان ثنتان.
ثم جئت رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو ببَقيع الغَرْقَد،([8]) قد تبع جنازة رجل من أصاحبه، وعليّ شملتان([9]) لي، وهو جالس في أصحابه، فسلمت عليه ثم استدرت أنظر إلى ظهره هل أرى الخاتم الذي وصف لي صاحبي. فلما رآني رسول الله صلى الله عليه و سلم استدبرته عرف أني أستثبت في شيء وُصف لي، فألقى رداءه عن ظهره، فنظرت إلى الخاتم فعرفته، فأكببت عليه أقبّله وأبكي، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «تحوّلْ!» فتحولت فجلست بين يديه، فقصصت عليه حديثي، فأعجب رسولَ الله صلى الله عليه و سلم أن يسمع ذلك أصحابُه..([10])
شعور المنافسة
يقول المغيرة بن شعبة: إن أول يوم عرفتُ رسول الله صلى الله عليه و سلم أني أمشي أنا وأبو جهل في بعض أزقة مكة، إذ لقينا رسول الله صلى الله عليه و سلم، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لأبي جهل: «يا أبا الحكم! هل لك إلى الله وإلى رسوله، وأدعوك إلى الله؟» فقال أبو جهل: يا محمد هل أنت مُنْتَهٍ عن سب آلهتنا؟ هل تريد إلا أن نشهد أنك قد بلّغت؟ فنحن نشهد أن قد بلّغت، فوالله لو أني أعلم أن ما تقول حق لاتّبعتك. فانصرف رسول الله صلى الله عليه و سلم، وأقبل عليّ فقال: والله إني لأعلم أن ما يقول حق، ولكن يمنعني شيء: إن بني قُصَيّ قالوا: فينا الحِجابة، فقلنا: نعم، ثم قالوا: فينا السِقاية، فقلنا نعم، ثم قالوا: فينا الندوة، فقلنا: نعم، ثم قالوا: فينا اللواء، فقلنا نعم، ثم أطعموا فأطعمنا، حتى إذا تحاكَّت الرُكَب قالوا: منا نبي. والله لا أفعل.([11])
وفي رواية أخرى أن أبا جهل قال: تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، أطعموا فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا، حتى إذا تجاثينا على الرُكَب وكنّا كفرسيْ رهان، قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فمتى ندرك هذه؟ والله لا نسمع به أبداً ولا نصدقه.([12])
واجتمع رجال قريش وقرروا أن يرسلوا عُتْبة بن ربيعة لكي يكلم النبي، ويقنعه للعدول عن دعوته. وكان عتبة هذا يعدّ من حكماء قريش، ومن المقدَّمين في قريش، وكان أديباً، وشخصاً موسراً. فقام عُتبة وذهب إلى الرسول صلى الله عليه و سلم، وأراد أن يلعب معه لعُبة المنطق، فقال له: يا محمد أنت خير أم عبد الله؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه و سلم، فقال عُتبة: أنت خير أم عبد المطلب؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه و سلم ولم يجبه.. ربما كان سكوته هو الجواب المناسب للأحمق. فقال عتبة: فإن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك، فقد عبدوا الآلهة التي عبدت، وإن كنت تزعم أنك خير منهم، فتكلم حتى نسمع قولك.
فقال رسول الله: «أفرغت يا أبا الوليد؟» قال: نعم. فبدأ رسول الله صلى الله عليه و سلم يقرأ عليه سورة فصلت: {بسم الله الرحمن الرحيم ` حم ` تنزيل من الرحمن الرحيم ` كتاب فُصِّلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون ` بشيراً ونذيراً فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون ` وقالوا قلوبنا في أكنّة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وَقْر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون ` قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين ` الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون ` إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون ` قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنداداً ذلك رب العالمين ` وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدّر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ` ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين ` فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم ` فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود} (فصلت: 1-13).
فلما وصل النبي إلى هذه الآية ارتجف عُتبة كمن أصابته حُمّى، ومدّ يده إلى شفتي الرسول صلى الله عليه و سلم قائلاً ومتوسلاً: اصمُتْ يا محمد بحق إلهك الذي تؤمن به! ثم قام عُتبة إلى أصحابه، فقال بعضهم لبعض: نحلِف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلسوا إليه قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي أني والله قد سمعت قولاً ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا الكهانة. يا معشر قريش أطيعوا واجعلوها بي. خلُّوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه واعتزلوه، فوالله ليكونَنّ لقوله الذي سمعتُ نبأ، فإن تُصِبْه العرب، فقد كُفيتموه بغيركم، وإن يَظهر على العرب، فمُلكه ملككم، وعزّه عزكم، وكنتم أسعد الناس به. قالوا: سَحَرَك والله يا أبا الوليد بلسانه. قال: هذا رأيي لكم، فاصنعوا ما بدا لكم.([13])
أسباب أخرى
لم تكن هذه الاعترافات اعترافات فردية تعود لشخص أو شخصين، بل كانت هذه قناعة عامة لديهم، ولكن أسباباً سلبية كانت تمنعهم من الإيمان به، مثل مشاعر الخوف والطمع والحرص والعناد. أجل، فمع أنهم يعلمون أنه نبي، إلا أنهم كانوا يعاندون في الإيمان به. ويشرح القرآن الكريم حالهم هذه وهو يسرّي عن الرسول صلى الله عليه و سلم، فيقول: {قد نعلم أنه لَيحزُنك الذي يقولون فإنهم لا يكذّبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون} (الأنعام: 33).
إنهم يلصقون بك تهماً عدة، وأنت تحزن من هذه الاتهامات الباطلة ولكن إياك أن تحزن مما يتقوّل عليك هؤلاء البائسون المغلوبون تحت ثقل أجسادهم، الأسارى بيد شهواتهم، العاجزون عن مغالبة عاداتهم. والحقيقة أنهم لا يكذبونك، إذ لا يستطيعون إسناد الكذب إليك، فأنت بريء من الكذب، وقد سبق وأن دعوك بـ“الأمين.” وانظر إلى مدى حماقتهم، فهم لا يؤمنون بما يسندونه إليك، ومع ذلك يتجرؤون على ذلك.. إذن، فلا تحزن.
أجل، إن كان هناك من يجب أن يحزن فهو هؤلاء القوم الذين عادَوْا من بيده خير الدنيا والآخرة، والذين لم يفتحوا قلوبهم للنور وهم على مقربة منه.
([1] مـختصر تفسير ابن كثير» للصابوني 1/140؛ وانظر: «الدر المنثور» للسيوطي 1/357
([2]) البخاري، الأنبياء، 1، مناقب الأنصار، 51؛ «المسند» للإمام أحمد 3/108، 271، 272
([3]) الحَرّة: كل أرض ذات حجارة سود. (المترجم)
([4]) كَلْب: اسم قبيلة عربية. (المترجم)
([5]) عَذْق: النخلة. (المترجم)
([6]) قُباء: أصله اسم بئر عُرفت القرينة بها. (المترجم)
([7]) العُرَواء: الرعدة والانتفاض. (المترجم)
([8]) بَقيع الغَرْقَد: مقبرة أهل المدينة وهي داخل المدينة. (المترجم)
([9]) الشملة: الكساء الغليظ يشتمل به الإنسان أي يلتحف. (المترجم)
([10]) «السيرة النبوية» لابن هشام 1/228-234
([11]) «البداية والنهاية» لابن كثير 3/83؛ «كنز العمال» للهندي 14/39-40
([12]) «البداية والنهاية» لابن كثير 3/83
([13]) «البداية والنهاية» لابن كثير 3/81-82؛ «السيرة النبوية» لابن هشام 1/313
يمنعهم من الإيمان به، ويقف حائلاً دون ذلك. وكانت هذه المعرفة دقيقة وواضحة إلى درجة أن نظرة واحدة منهم لرسول الله صلى الله عليه و سلم كانت كافية للإيمان به، ذلك لأنهم كانوا يعرفون هيئة رسول الله صلى الله عليه و سلم وشمائله وصفاته، ويشير القرآن الكريم إلى هذه الحقيقة فيقول: {الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإنّ فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون} (البقرة: 146).

 الأحد 5 يناير 2020 - 16:49 من طرف swayli
الأحد 5 يناير 2020 - 16:49 من طرف swayli